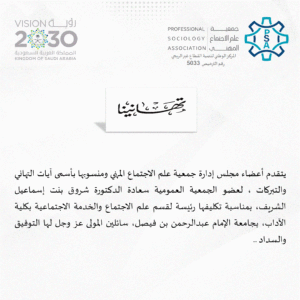الاغتراب الثقافي: حين لا يشبهك أحد في الوطن أو في المنفى .. بقلم د. شروق إسماعيل الشريف
- الأخبار
تاريخ النشر: 21 ديسمبر / 2025
في كل مرة يعود فيها خالد إلى وطنه يشعر أن قلبه يسبق قدميه.. الشوارع، رائحة القهوة، والبخور، بيت الجد.. كل شيء فيه يُشعره أنه عاد إلى حضنٍ يعرفه، وطنه ليس مكانًا غريبًا عنه، بل العكس تمامًا، هو يحبه، ويشتاق له، يحلم به حين يطول به المقام في الغربة، لكنه رغم هذا الحب يصطدم كل مرة بحاجزٍ لا يُرى…
ما يلاحظه خالد ليس رفضًا، بل نوع من الاختلاف الذي يشعر به عما حوله، المفردات التي يستخدمها.. مفاهيمه غير مألوفة تمامًا.. أولوياته مختلفة بعض الشيء، وذاك وحده كافٍ ليُشعره بأن الانتماء لا يعني التشابه بالضرورة.
يُطلق على هذا الطفل وصف “أطفال الثقافة الثالثة”، وهو مصطلح ظهر منذ ستينيات القرن الماضي، لوصف الأطفال الذين نشأوا في بيئة تختلف عن الثقافة الأصلية لوالديهم؛ نتيجة الهجرة، أو العمل، أو التنقل المستمر بين الدول. هؤلاء الأطفال تربوا –خلال سنوات عمرهم الأولى- خارج وطنهم، فهم لا يذوبون تمامًا في ثقافة البلد المضيف، بل تتكوّن لديهم هوية هجينة، فيها من كل مكان صورة، لكنها ليست صورة طبق الأصل لأي مكان.
هذه “الثقافة الثالثة” ليست بلدًا جغرافيًا، بل تجربة نفسية واجتماعية، يعيشها هؤلاء الأطفال حين يتربون في أكثر من بيئة، وتتقاذفهم أكثر من ثقافة، ويتعلّمون الترجمة المستمرة بين العوالم التي يتنقّلون فيها. وهم ، في كثير من الأحيان ، يتمتعون بمرونة عالية، ومهارات كبيرة، ويتحدثون لغتين أو أكثر، لكنهم يدفعون أيضا قد ثمنًا فادحًا حين يُطلب منهم أن يكونوا “نسخة واضحة” من أي جماعة.
ومع ازدياد حركة السفر، والابتعاث، والعمل خارج الحدود، أصبحت هذه التجربة شائعة أكثر في العالم العربي. فهناك جيلٌ كامل من الأطفال الذين ولدوا خارج المملكة في فترة ابتعاث أو عمل والديهم، والتي قد تمتد إلى 6 سنوات، و كذلك الذين نشؤوا في بلدان الخليج، وهم من أصول عربية أخرى، أو رافقوا آباءهم في بعثاتٍ أوروبية وأمريكية، أو وُلدوا أصلاً في الخارج. لكن التحدي الأكبر يبدأ غالبًا عند العودة إلى الموطن الأم.
لحظة العودة إلى الوطن تبدو دائمًا في بداياتها لحظة ميلادٍ جديدة، تُغسل فيها الروح من غبار الغربة، وتُزهر على أعتابها وعودُ البدايات.. هذا الطفل (خالد) مثل كثيرين غيره، يحلم بعودته إلى بلده كما يحلم المرء بلقاء صديق قديم. في مخيّلته تفاصيل المكان الذي لم يكبر فيه لكنه ظلّ يسكنه في الخيال، وشعور عميق بأنه سيكون أخيرًا بين أهله وخلّانه.
لكن الواقع لا يشبه الحلم دائمًا، فبينما يحتفي خالد بكل لحظة يعيشها، من الأكلات الشعبية التي تستعيد ذاكرة الطفولة الأولى، إلى دفء جلسات بيت الجد التي تفوح منها رائحةُ الحكايات القديمة، فإذا أشياء أخرى تبدأ في الظهور.. نظرات تُطيل التحديق، تعليقات صغيرة على أسلوبه في الحديث، استغراب، كونها غريبة عليهم.. لم يكن يتوقع أن العودة إلى الوطن قد تحمل هذا القدر من التباين بينه وبين من وُلدوا فيه.
إن ثمة حقيقة أخرى باتت تتشكل في الظل، فكلما تعمق في تفاصيل الحاضر وجد أن لوحة الماضي التي رسمها في خياله لم تعد تطابق الأصل، صارت بهجته غطاءً رقيقًا يخفي تحته خيوط غربةٍ جديدة، غربة الألفة التي تغيرت ملامحها، وأصوات الأماكن التي بهتت في غيابه.
إن أبناء الثقافة الثالثة –في الواقع- لا يملكون ثقافة “أجنبية” بالمعنى التقليدي، بل هي ثقافة هجينة، تشكّلت من خليط التجارب التي مرّوا بها في دول مختلفة، ومدارس مختلفة، وأوساط اجتماعية متعددة، ولغات متعددة، وهذا لا يعني أنهم “تشبّهوا بالغرب” أو أنهم فقدوا هويتهم الأصلية، بل يعني ببساطة أنهم أعادوا تشكيلها.
من منظورٍ اجتماعي يمكن فهم هذا من خلال فكرة “التنشئة المركّبة”؛ فهؤلاء الأطفال لم يتربّوا ضمن ثقافة واحدة، بل عايشوا أنظمة قيمٍ وسلوكٍ وتواصل متباينة، جعلت فهمهم للحياة والوقت والعلاقات مختلفًا عن أبناء الثقافة الواحدة، كنتيجة طبيعية لبيئة تنقّلٍ متواصل، لكنّ المجتمع غالبًا قد يرى أنه خارج مألوف ما اعتاد عليه أبناؤه المقيمين في رحابه.
وإذا ما التحق خالد بمدرسة عادية، ليست عالمية، تبدأ المواجهة الحقيقية.. كلمات لم يسمع بها، وأكواد اجتماعية لا يعرفها. الأسوأ من ذلك حين يتحوّل اختلافه إلى مادة للتنمّر: “ليش تتكلم كذا؟”، “وش قصدك؟”، أو في أفضل حالٍ تجاهل تام من أقرانه في الصف، وكل هذا يقع في أوجِّ مرحلة عمرية حرجة، تُصقل فيها الهوية، وتُبنى جسور الثقة، وتتوق النفس فيها إلى مرسى القبول.
قد يواجه العائدون من رحلات عمل أو دراسة طويلة ذات الصراع، لكن قدرتهم على التجاوز غالبًا ما تكون أيسر، أما بالنسبة للناشئة فإن الأهل في غمرة فرحتهم بعودة ابنهم قد لا يدركون أنه يخوض معركة صامتة في داخله.
فإذا لم يجد الدعم الكافي -خاصة في لغته العربية- نما في نفسه شعورٌ بالنقص لا يبوح به.. يرقب أقرانه وهم يتجاذبون أطراف الحديث بتلقائية تامة، بينما يصارع هو في ذهنه لثوانٍ معدودة، يترجم فيها الكلمات قبل أن ينطق بها، وحين تلسعه سهام السخرية جهله بتعبيرٍ دارج، يبدأ الشك يتسلل إلى روحه، وتهتز ثقته في قدرته على أن يكون جزءًا من هذا النسيج الذي يشعر أنه يلفظه.
المشكلة هنا ليست في الطفل، بل في غياب التهيئة الأسرية والمجتمعية، فكثير من الآباء يكتفون بالفخر بأن ابنهم يتكلم اللغة الانجليزية بطلاقة، دون أن يدركوا أن ضعف العربية في السياق المحلي عاملٌ قد يضعف ثقته بنفسه، ويُشعره دومًا بأنه “أقل” من غيره في البيئة الجديدة.
وعلى الرغم من هذه التحديات فإن دراساتٍ متعددة تشير إلى أن أبناء الثقافة الثالثة يمتلكون مهارات نادرة: مرونة فكرية، سرعة تكيّف، ذكاء ثقافي مرتفع، وقدرة على التواصل مع المختلف.
في عام 2009 أجرى الباحثان Jean‑Marc Dewaele ، وJan Pieter van Oudenhoven دراسة علمية [1] شملت عينة من (79) مراهقًا في لندن، نصفهم صُنّف كأطفال الثقافة الثالثة (TCKs)، بناءً على أنهم ولدوا في الخارج، أو تنقلوا وكانوا في بيئاتٍ لغويةٍ متعددة، وقد أظهرت الدراسة أن هؤلاء الأطفال قد سجلوا درجاتٍ أعلى بشكل ملحوظ في الانفتاح الثقافي، بينما كانت درجاتهم في الثبات العاطفي أقل مقارنةً بنظرائهم من بيئاتٍ أحادية اللغة والثقافة، وهذا يعني أنهم يميلون لقبول التنوع الثقافي بانفتاح أكبر، ولديهم حس تعاطف أعلى تجاه اختلاف القيم والسلوكيات بين الثقافات المختلفة.
وفي ذات السياق تُظهر أبحاث أخرى، مثل دراسة [2] Maarit Huikuri أن أبناء الثقافة الثالثة يتجهون إلى تخصصاتٍ ومهنٍ دولية، قيادية، أو ذات أثر إنساني وهي ميول مرتبطة بالتنشئة متعددة الثقافات.
إن أبناء الثقافة الثالثة ليسوا حالة استثنائية ولا ظاهرة غريبة، بل نتيجة طبيعية لعالم متغير، تُكسر فيه الحدود بسهولة، وتتشكل فيه الهويَّات خارج الجغرافيا الضيقة، مشكلتهم ليست في اختلافهم، بل في قوالب الجماعة التي تضيق بالمختلف، حتى لو كان يحمل نية الانتماء.
هؤلاء الأطفال لا يحتاجون إلى أن “يتشبهوا” بغيرهم، بل إلى أن يُسمَح لهم أن يكونوا كما هم، وأن يُفهم اختلافهم كتجربة غنية، لا كخللٍ يجب تصحيحه، وهم يستطيعون أن يضيفوا للمجتمع أبعادًا لا يراها من لم يغادر حدوده يومًا، وربما السؤال الحقيقي ليس: لماذا هم مختلفون؟، بل: هل نحن مستعدون لأن نُوسّع تعريفنا للانتماء ليشملهم؟
إن المدرسة تحديدًا يمكن أن تكون نقطة التحوّل: إمّا أن تكون بيئة احتضان ووعي، تُمهّد لهم الطريق للاندماج بثقة، أو تكون أول مكانٍ يشعرون فيه بأن اختلافهم عبء. إن إعداد معلمين يحتضنون الاختلاف، وتنشئة طلابٍ يدركون ثراء التنوع، وفتح أبواب الفصول لتكون ملتقى للتجارب الإنسانية، هو استثمار في روح الوطن ذاته؛ لنبني مجتمعًا أرحب قلبًا وأكثر عدلًا، يرى في أطفال الثقافات جسورًا تعبر به إلى المستقبل، لا غرباء على أعتابه.
أما المجتمع نفسه، فهو مدعوّ لأن يُوسّع تعريفه للهوية والانتماء، ليدرك أن من نشأ على أكثر من لغة، في أكثر من بلد، يمكن أن يكون أكثر حبًا للوطن، وليس أقل من غيره، وأن التنوع لا يُضعف الجماعة بل يُغنيها، حين نعرف حقًا كيف نحتويه.
وتلك الأسئلة ربما كانت أهم بكثير من أي إجابة جاهزة!
[1] – Dewaele, J. M., & Van Oudenhoven, J. P. (2009). The effect of multilingualism/multiculturalism on personality: No gain without pain for third culture kids?. International Journal of Multilingualism, 6(4), 443-459.
[2] – Huikuri, M. (2013). Third Culture Kids’ Career Choices and Mission Call. Migration-Muuttoliike, 40(1), 25–32. Noudettu osoitteesta https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/90037